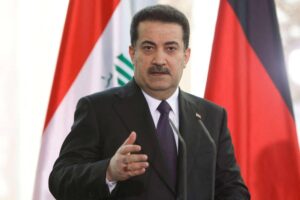[ad_1]
حينما حلَّت جائحة كورونا، وعصفت بالعالم أجمع، تباينت الآراء، واختلفت ردات الفعل، وظهرت خلطات شعبية لمكافحته، وعاش مواطنو العالم سنة كاملة ما بين مذهول بما حدث، ومنكر لحقيقة وجود فيروس ولقاح خاص به لاحقًا، وما بين مصدق لوجوده، وآخر يرى أنه لا يعد خرافة، أو حربًا بيولوجية. هذا التباين في وعي الناس وإدراكهم لما أحاط بهم طال الحكومات؛ فمنها من اتخذت الأمر كنكتة يتناولها في مؤتمر صحفي، ومنها من لامت المواطنين، وذكّرتهم بأن الفيروس سيحصد أقرب أقربائهم ليصل إليهم، وهناك من ذكر بلهجة حازمة أن غنى الدول لا يعني قدرتها على المقاومة، وأن هذا المرض لا علاج له، وأن مصير المصاب به الموت إن لم يستطع المقاومة بالبنادول والأكسجين.
وفي المقابل فقد حدث أن ظهر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بشكل يومي؛ ليُطمئن مواطنيه، وبادر بين فينة وأخرى وزير الصحة بالتذكير بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية. ولم يكن الاكتفاء بأولئك، بل ظهر من هو على رأس الهرم؛ ليقول إن الجميع يقف وقفة مقاومة لما يحدث.
مقارنة ردات الفعل الحكومية، وتبعات ما حدث، تجعل الفرد يستشعر أعظم نعمة وُهبت له، وهي نعمة الوطن، وتحديدًا نعمة الوطن الذي يرعى مواطنيه؛ ففي وسط رعب العالم كانت الرسائل مطمئنة، وخلال ذهول الجميع وعدم القدرة على السيطرة كانت قرارات محاولة السيطرة حازمة ورادعة؛ فالهدف الرئيس حماية الإنسان، والمحافظة عليه، الإنسان الذي لم يكن هناك اشتراطات لجنسه أو جنسيته، ولم يصدر أي توجيه بأن يكون هناك استثناءات لأفراد دون آخرين، في وقت كانت فيه بعض الدول ترعى الغني وتترك الفقير يواجه مصيره!
من قلة الوفاء، وعدم الإدراك، محاولة حصر عطاء وطن في حادثة أو جائحة، لكنها الأيام حينما تختبر أهلها، وتريهم قدر ما لم يدركوا قدره.. فالواجب لرد بعض الجمائل تكاتف الأيدي، وتضافر الجهود؛ فالجميع مسؤول، والوعي ليس مسؤولية قطاع أو جهة واحدة؛ فالحرب يخوضها البشر باختلاف توجهاتهم وأفكارهم وأجناسهم، وحينما تقصر مجموعة بسيطة من الأفراد فهي تضر منظومة متكاملة ومساحة كبيرة من الأرض، فماذا يمكن أن يقدم المرء لبلد تجاوز عطاؤه مواطنيه؟!
الأوطان ليست بحاجة لشعارات تُردَّد بقدر حاجتها لسلوكيات تعكس مقدار الانتماء.
[ad_2]
Source link